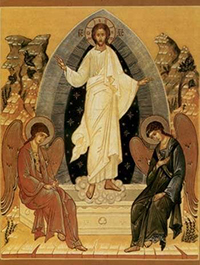 “المسيحُ قَامَ” .. كلمتان. لقبٌ وفعل. لقبُ الوظيفةِ التي أخذها من الآب، وفعلٌ ثالوثيٌّ استُعلِنَت فيه الحياة.
“المسيحُ قَامَ” .. كلمتان. لقبٌ وفعل. لقبُ الوظيفةِ التي أخذها من الآب، وفعلٌ ثالوثيٌّ استُعلِنَت فيه الحياة.
حياةٌ لم تعرف الموت، جاءت إلى جسد الموت. النورُ أشرق في ظلمة الدهور التي جلبها آدم الأول، الذي أَسَرَ الحياة للقبر، ورصد الفساد للكون، وأخضع الخليقة للبُطل (رو 8: 20).
مِن رَحِمِ حواء نزل الكلُّ إلى القبور، ومن الأرض، من ترابها أكلنا ثماراً تُرابيةً تَفسَدُ، تعود إلى أصلها، فليس الجسدُ وحده مِن ترابٍ وإلى التراب يعود، بل أيضاً ما التصق بالجسد يبلى معه؛ لأنه “من ترابٍ وإلى التراب يعود”. هكذا يقف الترابيون -معاً- عند حافة القبور؛ لأن “شوكة الموت” (1كو 15: 56) غاصت، ليس فقط في الجسد، بل في الروح أيضاً؛ لأن شوكة الموت هي الخطية (1كو 15: 56) وشوكة الخطية هي الشريعة (1كو 15: 56).
ذلك كان هو الليل الداهم الطويل الذي لَمَعت فيه أنوار النبوة، وأشرقت فيه ملامحُ الرجاء الآتي على وجوه وشفاه البطاركة والملوك والأنبياء، حتى السابق الصابغ الشهيد الذي سجد لمن جاء ببشارة الحياة.
* * *
أَشرَقْتَ بالحياة طفلاً؛ لأنك خالق الأطفال. ووُلِدتَ في حقارة البشَرِ؛ لأنك لا تحتاج إلى كرامةِ وشرفِ ومجدِ البشر .. ماذا يمكن للترابيين أن يقدموا لك؟
أَخَذتَ من البتول جسداً مثل أجسادنا؛ لأنك أحببت الخطاةَ والمساكين والمكسورين والضعفاء .. لم تكُن تسعى لِمَا اخترعه البشر من ألقابٍ، ومن كرامةٍ، ومن حياةِ ترفٍ براقةٍ تخفي تحتها الفناءَ؛ لأن الفناءَ هو انهيارُ ما يُبنى بأيدي الهالكين، وضياع صورته، وانحلال قوامه، وانقطاع تواصله مع ما هو كائن.
لكنك جئتَ بالحياة لكي تدوسَ موتَ الولادةِ، ووُلِدتَ؛ لكي تحاصرَ وجودنا المحدود بالزمان، بالبدء وبالنهاية، فترفعَ البدءَ إلى بدءٍ جديدٍ تُجرِّدُ فيه زمانَنا لكي يرى بذرةَ الحياةِ وقد عادت إلى الكلمة، إلى بارئها، ليس بنطقِ “ليكن” (تك 1: 3)، بل بمحبةِ الاتحاد: “القدوس المولود منك يُدعى ابن الله” (لوقا 1: 32).
لقد جاء الفجرُ وأشرق “شمسُ البر” وفي جناحيه الشفاءُ (راجع ملا 4: 2).
* * *
الكُلِّيُ الحكمةَ يقبلُ جهلَ الإنسانِ، ليقولَ الحقَ عندما يُسأل عن اليوم والساعة، فإذ هو لا يعرف (مرقس 13: 31). هو لا يعرف؛ لأننا نظنُ أنه لا يجبَ أن يبوحَ بالسرِّ، وهذا جيدٌ.
هو لا يعرف؛ لأنه نَظَرَ بعيني آدم وبوجدانه إلى آفاق الوجود، فلم يستطع أن يرى، وهذا بدوره جيدٌ.
كان يعرفُ دورةَ الوجودِ ونهايةَ الأزمنةِ كلِّها، فهو الخالق الذي شاء فخَلَقَ الكلَّ من العدم ورَسَمَ نهايةَ الوجود .. لكن ما أبعد الفرق بين وجودٍ رُسِمَ حسب عناية الخالق، ووجودٍ تزامنت نهايتُه مع فشل آدم في أن يكون إلهَ هذا الكون (مزمور 8: 5).
فغرقَ الكونُ في ظلام الموت، ظلامُ نهايةٍ لا يعرفها الخالق؛ لأنه لم يخلقها، فهو يعرف ما يخلق، ولكن تلك النهايةَ الفاشلةَ، نهايةٌ وفناءٌ لا علاقة له بالخالق. لم يؤسِّسُ الخالقُ الفناءَ، بل أسَّس الحياةَ .. وهذا جيدٌ.
لكن عندما تسمعُ سؤالَ البشرِ عن نهاية الزمان، فالمعرفة الاختبارية الذوَّاقة النابعةُ من الكيان الإنساني الذي لا يعرف، هي إجابةُ الحقِّ، وهي بدورها لا تنتقصُ من قَدْرِ الإلوهةِ؛ لأن الكاملَ أخذ ما هو ناقصٌ .. ووَضَعَ نفسَه داخل حدود الكيان الذي لا يمكنه أن يرى، فقال إنَّ ابن الانسان لا يعرف (مرقس 13: 31)، ولكن الآبَ يعرفُ … لم ينقسم الثالوث، ولا مَسَّ الجهلُ جوهرَ اللاهوت، ولكن جاء الكُلِّيُّ المعرفةَ إلى جهل الإنسان؛ لكي يفدي ذلك الجهل (راجع أثناسيوس العظيم، المقالة الثالثة ضد الأريوسيين: 34 – 35). لقد أخذ الجهلَ، ونطقَ بالجهلِ، كما سأل عن مكان الدفن في يوم السبت (سبت لعازر) الذي سبقَ السبت الكبير (سبت القيامة).
مع الجاهلين باليوم والساعة، خَضِّعْ نفسَكَ كواحد منهم؛ لأنك سترفع بصرَ آدم الجديد؛ لكي يرى اليوم والساعة عندما يمر من ظلام القبر إلى نور الحياة.
مَن الذي يمكنه أن يدركَ كيف تجوَّلَ في ثنايا الوجود الإنساني في ثوبِ كياننا الذي خَرَقَه الموتُ، وطبعَ فيه رقعةً للجهلِ، ورقعةً للموت، وأخرى للفساد، ورابعةَ للمرض، وخامسةً للضعف، وسادسةً للقُبح، وسابعةً للذل والعبودية. لقد اكتمل نصابُ الرُّقَعِ؛ لأن الثوبَ القديم يجب أن يُنسجَ من جديدٍ، ويلبَسُ الحياةَ والمجدَ والمعرفةَ والخلودَ والشركةَ وعزةَ الألوهةِ.
* * *
على أنَّ القديمُ الآتي من آدم الأول لم يكن ثوباً بالياً يُلقىَ به في العدم، بل على نُول “نسَّاج” الروح، خالق الحياة الرب المحيي يُنسَجُ من جديدٍ. ذات الخيوط القديمة، تنال صبغة الروح القدس؛ لكي يرفع الروحُ قِدَمَ الحياةِ ويعطي لها “لُحمَةً” جديدةً باغتسالها في مياه الأردن؛ ولذلك لم يتعرف عليها العدو القديم؛ فسأل في دهشةٍ: “إن كنتَ أنت ابن الله، هل كنتَ في زمانٍ سابقٍ ابناً لله، أم في زمانٍ آتٍ، أم أنك آخرٌ آتٍ؟ إن كنت … إن كنتَ … ولكنك لا تُشرِكَ الخبيثَ في سِرِّكَ، ولا تبوحَ بهويَّتِكَ إلَّا لمَنْ يُحبُّكَ ولا تجيبَ عن باطلٍ يلبَسُ ثوبَ معرفةٍ، وإلَّا لأمكن للباطلِ أن يجرح -بزيفِ المعرفةِ- وجهَ الحق.. وهكذا تركت الخبيثَ يفكر حسب جُبنه؛ لأنه لا حقَّ له عندك يلتمسُ فيه إجابةً.
* * *
من البريِّةِ عَدتَ ناصعاً ببريق الظَفَرِ، وهكذا حوَّلت الماء خمراً في عُرسٍ (يوحنا 2: 11)؛ لأنك تفرح بالزواج، فهو رسمُ اتحادك بالعروس الكنيسة (أفسس 5: 32). وصرت تطوفُ تشفي وتطرد الأرواح النجسة وتحرر البشرَ من القيود، قيود الكراهية والعبودية للحرف في بيت سمعان الفريسي. فقد جَلَبَ مَن يحفظ الشريعةَ زانيةً لكي يمتحن نزاهتك وطهارتك. ولكن الزانية قبَّلت رجليك، ولمحت فيك طهارةً لم ترها في رجالها الذين يشترون جسدها. سكبت دموع روحها مثل دموع العينين.
يعلمُ التائبون إنَّ دموعَ الروحِ هي قطراتُ، بل طوفانُ أهاتِ الندم على خسارةٍ حَلَّت، ودمارِ جمالٍ أفسده الشوقُ للاتحاد الجسداني، وهو وهمٌ عريضٌ، وعطبٌ يقفرُ الروحَ من جمالها ويجرح براءة الضمير … هكذا بَكَتْ .. ومسحت بشعر رأسها قَدَمي البريء الذي لم يكن في قلبه ثمةُ شهوةٍ … فَسَرَتْ من قلبه الحُرِّ نسمةُ حريةٍ رَفَعَتْ بؤسَ وشقاءَ الزنى …
* * *
امتحان العهد الجديد لا فضل فيه للفريسيين، فقد أمسكوا بزانيةٍ وجاءوا بها إلى يسوع في تحدٍّ ونشوةِ ظَفَرٍ … شريعتُنا تحكم بالرجم، فماذا تقول أنت؟ لو قال: لا، لَهَجَمَ عليه حافِظو حرفَ الشريعةِ ومخالفو روحَها في قلوبهم حيث صراع الشريعة مع الشهوات .. ولكنه طَلَبَ الأبرياءَ بينهم، وجلس يكتب .. قال البعض إنه جلس يكتب أسماء الزناة بينهم. وقال آخرون، بل اسم الرجل الزاني، وقال ثالثٌ، بل الخطايا المستترة بما فيها كسر وصية السبت .. وفي النهاية خاف الكلُّ وهربوا .. لو كان يسوع قد حكم بالرجم على تلك المرأة، لَسَقَطَ العهدُ الجديدُ برمته تحت وطأة الشريعة.
* * *
عندما جاء المخلص إلى مخاضِ الموتِ، قال للآب: “مجِّدني أيها الآب بالمجد الذي كان لي عندك قبل خلق العالم” (يوحنا 17: 5)، وسَمِع صوتُ الآب: “مجَّدتُ وسوف أمجِّدُ أيضاً” (يوحنا 12: 28). تلك ومضاتٌ رأى فيها الربُّ نهايةَ العالم، ليس العالم المخلوق حسب إرادة الله، بل العالم الذي زَيَّفَه الانسانُ، أي “ممالك العالم” (لوقا 4: 5) تلك التي وُضِعَتْ تحت وطأة رئيس العالم (يوحنا 16: 11) الآن سيأتي .. وليس له في كيان يسوع شيء، فقد “مُجِّدَ” يسوعُ بالمجد الذي كان له قبل خلق العالم، ورأى الحروبَ، وسقوطَ اورشليم والمجاعات والأوبئة .. ثم المنتهى .. رأى اليوم قبل مخاض الموت وعاين ساعة “دينونة العالم” (يوحنا 16: 11) قبل أن يُصلب: الآن يُطرح رئيس هذا العالم من على كرسي قوته؛ لأن يسوعَ سوف يموت لكي تنقضِ مملكةُ الموت.
* * *
عند الإقرانيون صلبوا الرب .. وحسب تراثنا الآرامي القديم كانت جمجمة آدم في ذلك المكان .. وحيث توجد أيةُ جمجمةٍ آدميةٍ، يوجَد الإقرانيون.
* * *
يقول اثناسيوس العظيم إنَّ الرب يسوع هو “رب الموت” (ضد الأريوسيين 2: 14) وهو حتماً ربُّ الحياة. فكيف ساد ربُّ الحياةِ على الموت؟
باللفظ يظل الفساد فينا.
لكنه قَبِلَ في جسده موتنا نحن وليس موته هو، فهو لم يخطئ ولا وُجِدَ في فمه غشٌ (1 بطرس 2: 22)، ولكننا نحن وهو حياةٌ واحدة، بشريةٌ واحدة. رأسٌ حُرٌّ وأعضاءٌ مقيَّدة، كرمةٌ تحمل في جذرها الحياة، وتمد ساقها نحو البراعم … ربُّ الحياة بالحياةِ اقتنص الموتَ، فقد أخَذَ الموتَ في جسده، ذلك الجسد الذي كُوِّن بروح الحياة لكي يغلب الموت .. يسود على الموت؛ لأن الإنسان هو الذي جَلَبَ الموتَ على كيانه .. بالخطية دخل الموت إلى العالم (رو 5: 12). ولم يكن الله هو خالق الخطية، بل الشيطان والإنسان. استدار الإنسان نحو كيانٍ خُلِقَ من العدم، فوجد العدم … دخل فيه خوف الموت (القديس اثناسيوس، الرسالة إلى الوثنيين 3: 14)، ومع رعدة الموت سعى نحو الخلود في الكون، وفي الجسد، وفي الأنظمة والكيانات التي يخلقها؛ لكي تحل محل الله، ولكي تملأ فراغ الوجود الذي ملأه الإنسان بالأوثان، الذي بعد أنْ ضَلَّ الطريق إلى الله، طَلَبَ الحياةَ من كيانه، فوجد الموتَ؛ لأن الكيان الإنساني ليس ذاتي الحياة. وَجَدَ الموتَ، وجاء يسوع إلى موت الإنسانية لكي يحوِّلَه إلى أداةِ تجديدٍ، فقد جَدَّدَ الموت، إذ حوَّله إلى معولٍ يهدم الإنسان القديم؛ لكي يبني يسوعُ الإنسانَ الجديد، لذلك صُلِبَ .. مسامير تثبيت الصليب في المصلوب، هي مساميرٌ يقدِّمُها الإنسانُ صانعُ الموتَ وجابلَه بالخطية لكي يقدِّمَ يسوعُ الحياةَ .. يقبلُ الموتَ من ايدي البشر لكي يعطي للبشر الحياة .. هو ربُّ الأحياء، وهو ربُّ الأموات الذين نزل إليهم في ظلام الجحيم فسبى الأسرى.
* * *
قامت الحياةُ بالميلاد من البتول، عندما صار الكلمةُ بدءَ الوجود الجديد.
قامت الحياةُ بمسحة الروح، عندما أعاد يسوعُ الروحَ للإنسانية كَمِسحَةٍ أبدية.
قامت الحياةُ، عندما صُلِبَ فقد نزع الصليبُ الموتَ من جسده؛ لأنه جعل الصليبَ علامةَ ظَفَرٍ، ومَزَجَ الصليبَ بكيانه، إذ حَفِظَ الجروحَ التي جَرَحَه بها الأحباء (راجع زكريا 13: 6) حتى بعد قيامته. وهكذا يبقى جُرحُ الأحباء شاهدَ غفرانٍ لا حُكم ولا قاضِ على عدوان البشر، بل استعلانُ محبةٍ حيث البغضة، واستعلانُ رفقٍ حيث العناد، واستعلانُ رأفةٍ في مواجهةٍ تَصلِبُ العداوةَ؛ لأن هدير المحبة يفوق كل صرخات الذنوب.
* * *
تجوَّل بعد القيامة يفتش عن الشهود .. كل هؤلاء الشهود كانوا في رعبٍ من اليهود … كليوباس ولوقا الثاني الذي أحجم عن الافصاح عن اسمه، كانا يسيران في طريق منفرد نحو قرية عمواس (هدمها الاحتلال الاسرائيلي بعد 1967)، ولكن أعينهما “أُمسِكَت” لم تعرفا الرب .. مثالٌ لكل من يريد أن يعرفه كإنسان فقط، فلا يعرفه حتى كإنسان.
وبين “إمساك” العينين و”انفتاح العينين” يقع تاريخ الخلاص.
لقد “انفتحت عيني حواء على شجرة معرفة الخير والشر” ورأت أنَّ الشجرةَ “شهيةٌ للعيون”، وسقطت بالرؤيا في رِدَّةٍ نحو الذات، اختيار الذات self بدون الله .. شركةُ الذاتِ في الذات ليست سوى الموت … لكن التلميذين بعد أن سَمِعا التعليم، أخَذَ الحَيُّ الخبزَ وشَكَرَ وناولهما … وانفتحت أعينهما وعرفا أنه الرب (لوقا 24: 31). قبل ذلك كان القلبُ ملتهباً” فقد لَمَسَ لهيبُ “الروح القدس” قلبَي كليوباس ولوقا، ولكن الروح القدس لا يُلهب القلب ويشعله فقط، ولا هو يُعيد الذاتَ إلى الذاتِ، بل يقود إلى سِرِّ المسيح، إلى انفتاح العينين على رؤية الحي إلى الأبد.
* * *
قديماً رأى أشعياء الربَّ في الهيكل. أمَّا في العهد الجديد، فكان الربُّ واقفاً على شاطئ بحيرة طبرية … في العهد القديم قدَّم الشاروبيم “جمرة نار” ولمس شفتي إشعياء. ولكن عندما عرف بطرس أنَّ الواقف على شاطئ البحيرة هو الرب، وَجَدَ بطرسُ جمرةَ نارٍ (هي نفس الكلمة في إشعياء 6 ويوحنا anthraka) ولكن الجمرةَ -على شاطئ البحيرة- أعطت سمكاً مشوياً لبطرس ليأكلَ، ولكي يعترف بأنه يحب الرب؛ لأن المحبة “تستر كثرة من الخطايا”، ونزع عنه إثم الارتداد بالمحبة، وسمع قول الرب “اتبعني” (يوحنا 21: 19) إلى الحياة وإلى القيامة.
* * *
لم يكن هو وحده مثالَ الشَّكِ. قال مكسيموس المعترف إن الشَّكَ جيدٌ، إذا ظلَّ سؤالاً، ولكنه يصبح شراً إذا تحول إلى جوابٍ نهائي، وتوقف عن كونه سؤالاً .. كان الكل يَشكُ في القيامة .. وحسب الشريعةِ، كان توما شاهداً، والشاهدُ لابد وأن يكون شاهد عيان لا مجردَ “ناقلٍ”. لو قال أنا سمعت أنه قام ولكنني لم أراه، لَما عنت شهادته شيئاً .. ولكن الرؤيا .. رؤية الحيِّ كانت هي الشهادة .. وشهد توماً.
* * *
هل تعجَّب القارئ عندما قرأ أن ملاكين جلسا واحدٌ عند قدمي يسوع، والثاني عند الرأس .. (يوحنا 20: 12)؟ كلاهما شاهدٌ، وعلى فم شاهدين أو ثلاثة تقوم كل كلمة .. والرأس والقدمين هما معاً بداية ونهاية الجسد … الجسد كله قام … قيامة حقيقية.
أخبرنا ايسيذوروس أسقف بليوسيوم إن وجود شمعتين على المذبح هما شهادة السمائيين على قيامة الرب، فقد جاء الحي ووحَّد الكل تحت رأسٍ واحدٍ (أفسس 1: 22)، رأسٌ منه تولد كل الأعضاء الحياة حسب التسليم الرسولي (كولوسي 20: 19).
* * *
“بالضعف داس الربُّ القويَّ الذي غلب جنس البشر”، أي الموت. هكذا كانت كنيسة أورشليم ترتِّل في القرن الرابع والخامس، وكانت تضيف أيضاً: “بالشجرة التي أسقطت آدم .. جاءت شجرة الصليب وأعادت إلينا الحياة بالربِّ الحي والمحيي” “لنعظِّمَ الذي أدان الدينونة” وحَكَمَ على كل صور الدينونةِ؛ لأن “الرحمة تفتخر على الحكم” (يعقوب 2: 13).
كان قبولُ الموتِ ضعفاً لا زال يحير الأذكياء السكارى بالقوة، ولكن ماذا حدث؟
قَبِلَ الربُّ أن يكون “الحَمَل”، وأن يسمح “للسكين” أن “يجزَّه”، ولم “يفتح فاه”، وسِيقَ للذبح، وبذلك وصلت القوة إلى نهاية الطريق، لم يعد أمامها أكثر من ذلك .. واستهلكت القوة كل ما لديها، لكي تفرز الحياة -في هدوء- ما لديها من حياةٍ غالبة.
عندما كتب سولجنستين الأديب الروسي في قصته “الدائرة الأولى” أنه في معتقل ستالين حُرِمَ من اسمه ومن زوجته ومن كل شيء .. وامتد الحرمان إلى كل ما يمكن أن يصل إليه سلطان القهر، فقد بذلك قدرته لأنه لم يعد لديه ما يمكن أن يضيفه أو يزيده .. ولذلك قال اوغسطينوس: “جلست على قمة العالم عندما لم أعد أخاف شيئاً ولم أعد أشتهي شيئاً”.
وقال لوقيانوس الصوري ذلك المؤلف المجهول في كتابه “سقوط الآلهة”: “أين قوة الآلهة؟ هي في العبادة، فإذا توقَّفنا عن عبادتها، فقدت قوتها، ولكن أين قوة يسوع؟ هي في هبة الحياة، وما دُمنا أحياء، فإن قوة يسوع ستعمل فينا”.
هكذا عَبَرت القيامة حاجز القوة بالضعف،
وحاجز الزمان؛ لأنها غلبت الموت،
وحاجز الكراهية؛ لأنها أعطت حياةً،
وحاجز العداوة؛ لأنها جاءت بالفداء وبالمصالحة والسلام، وزرعت المحبة التي لا تموت.
وحاجز القوميات؛ لأن يسوع هو ابن الإنسان الذي -حسب المرجعية الآرامية- هو “آدم”، السابق على كل أسماء القوميات .. ولكنه أيضاً ابن الإنسان الحي الذي بالحياة، صار رباً ومسيحاً، فقد كسب معركة الحياة بالتواضع، وغلب بالمحبة، وصار رباً وخادماً ملكاً وعبداً، وقال ها أنا حيٌّ وكنتُ ميتاً، ولكنني حيٌّ إلى أبد الأبدين، وهنا ساد على الحياة بالقيامة، وعلى الموت بالصلب؛ لأن الصليب جعله ينزل إلى الجحيم وهناك سبى الجحيم.
* * *
وما أعظم ما لدينا في التسليم الليتورجي؛ لأن “الصليب هو ختم القيامة”، والقيامة هي قوة الصليب، وحيثما يُرشَم الصليب، فإنَّ نهاية الرشم هي: “الروح القدس” روح الحياة الذي أقام يسوع، والذي سوف يقيم أجسادنا بالروح ذاته (رو 8: 11).
- يا يسوع الحي
- أنت حيٌّ على عرش الحياة
- لأن عرش الحياة هو عرش اللاهوت
- لا حيَّ إلَّا الغالب
- وكلُّ مَن قال حيٌّ، ولم يذق القيامة،
- فقد نَطَقَ بكلمة بلا فعل، وبلا فاعل.
- يا يسوع الحي
- محبتُك حيةٌ .. تقوم دائماً فينا
- محبةٌ لا تموت
كلُّ عامٍ وأنتم بخير
د. جورج حبيب بباوي


